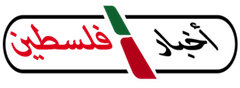شبكة قدس الإخبارية - 12/6/2025 9:36:25 AM - GMT (+2 )

ظاهرة الميليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ليست مجرد حدث عابر، بل نتاج مشهد شديد التعقيد تشكّل في ظل حرب الإبادة: فوضى أمنية، انهيار مؤسساتي، ومجموعات محلية تحاول ملء الفراغ في مناطق معزولة تحت الرقابة الإسرائيلية. ما يبدو من الخارج مجرد فوضى عابرة، هو في الحقيقة هندسة متعمدة تستثمر ضعف البنية المدنية والحكومية الفلسطينية لإنتاج نماذج بديلة يمكن التحكم بها.
مع تراجع المنظومة الأمنية المدنية في المناطق الشرقية لرفح، خصوصًا قرب معبر كرم أبو سالم، ظهرت مجموعات مسلحة ذات طبيعة جنائية تعتاش على سرقة المساعدات الإنسانية، وتخلق اقتصادًا مظلمًا، وتوظف عناصر هامشية ضمن منظومة فوضى متزايدة.
ومع مرور الوقت، تحوّلت هذه الظاهرة الإجرامية إلى أدوات يمكن استخدامها من قبل إسرائيل في سياق سياسي–أمني أوسع. وعندما اجتاح الجيش الإسرائيلي مدينة رفح وشرّد سكانها، أصبح هذا الواقع فرصة لتجريب نموذج محلي جديد، عنوانه: “بديل عن حماس” أو “غزة الجديدة”.
الرهان الإسرائيلي على هذه المجموعات يقوم على ثلاث وظائف رئيسية:
1. تقليل الخسائر البشرية: الاعتماد على قوى محلية بديلة في بيئة قتالية معقدة تضم أنفاقًا وبيوتًا مفخخة وكمائن مموهة.
2. تسويق نموذج حكم محلي: محاولة خلق واجهة سياسية بديلة يمكن استثمارها لتغطية غياب خطة لليوم التالي، وكسب الوقت لمواصلة الحرب، رغم أن مصير هذه الميليشيات غالبًا الفشل.
3. إدارة السكان: عبر إنشاء مناطق محكومة عسكريًا بالميليشيات، وبالتوازي مع كيانات إنسانية محتكرة (مثل مؤسسة غزة الإنسانية) تعمل تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لتنسجم فيها الأمن والإغاثة في يد جهة واحدة. الهدف هو نقل السكان إلى منطقة رفح بعد الفحص الأمني، تمهيدًا لمشاريع حشد ديمغرافي قد تفتح الباب لترتيبات تهجير قسري أو طوعي في المنطقة الحدودية مع مصر.
لكن كل هذا البناء انهار أمام حقيقة أساسية: لا يمكن لأي قوة تفتقد شرعية المجتمع أن تتحول إلى لاعب سياسي مستدام.
الرفض الشعبي كان حاسمًا؛ تعامل السكان مع أي مبادرة أمنية–سياسية مدعومة عسكريًا على أنها امتداد للاحتلال، لا “بديلًا وطنيًا”.
وذاكرة المجتمع، المليئة بتجارب جنوب لبنان وغيرها، كانت كفيلة بإسقاط التجربة قبل أن تنمو.
مع تراجع إمكانية تشغيل هذا “البديل المحلي” كواجهة سياسية، تحوّل دوره إلى وظيفة أكثر خطورة: أداة عملياتية للاحتلال داخل المناطق المأهولة، عبر الاغتيالات أو الخطف أو إثارة الفوضى، ما زاد من أزمة الميليشيات مع المجتمع وجعل التخلص منها محل إجماع شعبي.
وسط هذه الفوضى، تبرز حقيقة محورية لأي مجتمع تحت الاحتلال: الخلافات الداخلية الفلسطينية—مهما كانت شديدة—لا يمكن أن تتقدم على الخلاف الجوهري مع الاحتلال الإسرائيلي.
عندما يصبح الخلاف الداخلي أكبر من التناقض الأساسي، تتفكك الجبهة الوطنية، وتظهر القوى الهامشية، وتُفتح الأبواب لنماذج دخيلة تُفرض قسرًا على الناس.
وتجربة الجنوب تظهر بوضوح أن إسرائيل تستثمر خلافات الفلسطينيين الداخلية لتسويقها على أنها الخلاف الأساسي، ما يتيح لها التملص من مسؤولية الاحتلال، وتحويل الفلسطينيين إلى حالة تحتاج “وصاية وتأهيل” لإدارة خلافاتهم.
تجربة الميليشيات في غزة تقول بصوت مرتفع إن:
*. الاحتلال قادر على إدارة الفوضى، لكنه غير قادر على إدارة مجتمع لا يمنحه الشرعية.
*. النموذج المحلي المفروض ينهار حين تصطدم دعائمه برفض الناس.
*. أي مشروع لغزة ما بعد الحرب لن ينجح ما لم ينبع من إرادة المجتمع نفسه.
*. إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ضرورة ليس فقط لمواجهة الاحتلال، بل لقطع الطريق أمام أي قوة هامشية أو دولية تحاول فرض وصايتها على الفلسطينيين.
في نهاية المطاف، فشل تجربة الميليشيات مرتبط باصطدامها بثقافة سياسية ومجتمعية تعرف تمامًا الفرق بين القيادة التي تنشأ في أحضان الناس والقيادة التي تُصنع في ظل القوة العسكرية للاحتلال.
الفلسطينيون—تحت النار والجوع والتهجير—يُدركون أن صراعهم الأكبر ليس مع بعضهم البعض، بل مع الاحتلال.
وهنا تظهر الحقيقة الجوهرية: الحل في غزة لن يكون أمنيًا أو إنسانيًا أو عبر ميليشيات، بل سياسيًا جذريًا يرتبط بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب في إقامة الدولة والتحرر الوطني.
وفي هذا الوعي الشعبي، تكمن الحصانة الحقيقية ضد أي مشروع يُصنع في الغرف المغلقة أو على فوهة بندقية المحتل.
إقرأ المزيد