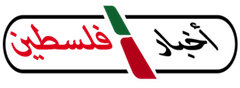وكالة سوا الاخبارية - 2/5/2026 9:11:28 AM - GMT (+2 )

توحُّش وإجرام، وقذارة «الغرب» بالصوت والصورة وبالوثائق، التي ما زال الجزء الأكبر منها مخفياً، وما زالت طيّ الكتمان في بعض جوانبها «الخاصة» على الأقل، وما خفي ليس مجرد أعظم، وإنما أغلب الظن ما زال هو الأخطر.
يستحيل على مراقب أو متابع عن كثب، مهما كانت قدرته، الإحاطة بكل هذا الكمّ من الوثائق، سواء أكان فرداً أم حتى مؤسسة، ويستحيل حتى على أكثر الصحافيين احترافية وحصافة حتى من فئة الصحافيين الاستقصائيين أن يحيطوا بالخلفيات والدوافع التي تقف خلف هذا الاجتياح المعلوماتي والوثائقي، حتى وإن استطاعوا الإحاطة بالسرديات العامة التي «تروي» أحداث هذه الفضائح وسياقاتها الزمنية، وتسلسل حدوثها، إضافة إلى محتوياتها.
إذا اتفقنا أن هذا القدر المرعب من القذارة والفجور قد صدم العالم، وفاجأ عشرات الملايين من البشر الذين يتابعون الأحداث في بلدانهم، وفي العالم، وأن غالبية هؤلاء مهما كانت قدراتهم الخيالية قد ذهلوا لهول ما سمعوا، وما تابعوا فإن القادم ما زال هو الأهم، وذلك لأن الأمور ــ كما أرى ــ لن تقف عند حدود القذارة والقبح والفجور، التي وصلت لها ما تسمى النخبة «الغربية»، علماً بأننا نتحدث عن نخب النخب، وعن «صفوة» ما زالت تتحكّم بثروات فلكية وبسطوة سياسية لا يشقّ لها غبار، وباحتكارات صناعية وتكنولوجية تحتلّ مراكز الصدارة والريادة.
إليكم بعض الأسئلة التي تطرح الآن لدى فئات واسعة في العالم كله.
كيف لشخص واحد، ومعه بعض الموظفين أن يوثّق هذا القدر من الوثائق؟ ألا يشي الموضوع بأن الأمر يتعلق بجهات مقتدرة، منظمة، ولديها ميزانيات مفتوحة، وتقف خلفها عشرات «المؤسسات» المحترفة والمختصة، هذا إذا كان الأمر يتعلّق بالثلاثة ملايين وثيقة فقط، وإذا ما كانت الأفلام المصوّرة هي عدة آلاف فقط، دون حساب حصر المراسلات والمكالمات؟
ثم من قال، إن الأمر يتعلق بهذه الثلاثة ملايين فقط؟
ماذا لو أن العالم استفاق غداً على خبر أن هذه الوثائق تزيد على ستة ملايين؟ ثم ماذا لو أن كلمة «يزيد» كانت تعني عشرة ملايين، على سبيل المثال؟
نعود للأسئلة التي تشغل بال المتابعين لفضيحة العصر، والتي ما زال «الغرب» كله يتعامل معها بمحاولات مفضوحة من التجاهل والتغافل، والتعاطي الإعلامي مقارنة بما تنطوي عليه من أهمية وخطورة، ومن إثارة يفترض أنها أكبر شأناً من الشؤون التي أتيح لي متابعتها في كبريات الصحف العالمية، وفي وسائل الإعلام الرسمية، وشبه الرسمية.
سؤال مطروح بقوة، وهو: لماذا حكمت المحكمة الأميركية بالإفراج عن الوثائق؟ وهل هناك جهات عملت بدأب ومتابعة للوصول إلى هذا القرار؟ أم أن الأمور وصلت إلى درجة أن إعاقة «الإفراج» كانت مستحيلة بعد افتضاح بعض جوانب الفضائح؟ أم يا تُرى أن المسألة تتعلق بأهداف أكبر وأخطر من كل هذه التفاصيل؟
وتطرح أسئلة أخرى من نوع ما هو شائع في منطقة الإقليم حول علاقة النشر بالحرب على إيران، وفيما إذا كانت عملية النشر مجرّد بداية ابتزاز لترامب، على تردّده في مهاجمة إيران، وهنا يجب أن نستذكر بأن أكثرة من 200,000 ألف وثيقة قد صدر قرار بحجبها عن الجمهور، دون الإفصاح عن سبب الحجب، ولا عن محتواها، وفي إشارة تتعلق على ما يبدو بكون أن الوثائق تتعلق بمسألة عسكرية أو أمنية حسّاسة، أو ما يعتبر في عدادها.
وهل فعلاً أن ثمة علاقة مباشرة ما بين الحرب على إيران وما بين نشر هذه الوثائق؟
وإذا كانت قرارات النشر التي أقرّت في لجنة الكونغرس ثم صدرت بقرار محكمة أميركية قد سبقت طبول الحرب، فهل كانت قد سبقت التوجّه إلى الحرب كقرار إسرائيلي أميركي سبق طبول الحرب بكثير؟
كما تطرح قضايا أخرى من نوع أن هذه الوثائق تتضمّن الكثير من المستمسكات المؤكّدة على قادة وعلى شخصيات نافذة على مستوى العالم كلّه؟ وأن هذه المستمسكات هي إحدى وسائل الضغط والابتزاز التي تمارس على قيادات العالم بمن فيهم قيادات وشخصيات لها قدر كبير من التأثير في قرارات وتوجّهات السياسة والاقتصاد؟
كما تطرح أسئلة أخرى، وعلى نطاق أكثر دقّة وحساسية بالمقارنة مع خارطة التوازنات الدولية الراهنة والمستقبلية.
أيُعقل أوّلاً ألا تكون المخابرات الروسية على الأقل ليست على علم بكل هذه الفضائح؟ ناهيكم عن «الغربية» والصينية.
أفلا يمكن أن تكون العملية قد دخلت عليها عدة جهات دولية، كل من زاويتها، وزاوية مصالحها واستهدافاتها في آن واحد، وأصبح النشر هو أهون الشرور؟
ثم، ألا يمكن أن تكون الحالة الداخلية الأميركية هي التي فرضت هذا النشر؟ وبهذا التوقيت بالذات، ولأسباب واعتبارات انتخابية، وما هو أبعد من الانتخابية؟
وفي هذا المجال تحديداً نطرح أسئلة متشعّبة.
ألا يمكن أن تكون جهات في الحزب الديمقراطي قد أثارت المسألة ــ حتى ولو أن رموزاً من الحزب كانوا متورّطين في الفضائح ــ بهدف «إقصاء» ترامب إن توفّرت معطيات ملموسة، والتي يبدو أنها، إما متوفّرة أو يمكن توفيرها؟
أم أن ترامب نفسه هو من أشار على «المعنيين» بملف الفضائح لكي يخلط الأوراق، ولكي يحوّل الانتخابات النصفية القادمة إلى مهرجانات للفضائح والفضائح المضادّة، وبذلك تضيع الفرصة على «خصومه» التركيز على الفشل الذي يغطيه من «ساسه إلى راسه»؟
بل وأبعد من ذلك، أفلا يمكن أن يكون ترامب نفسه وقد أدرك أن بلاده قد وصلت أمورها من زاوية القدرة على الهيمنة إلى طريق مسدود، أو أن ثمن الهيمنة أصبح مكلفاً إلى درجة عدم القدرة الأميركية على تحمّلها قد أراد أن «يُحمّل» العالم كلّه ثمن الأزمة الأميركية، وثمن الانكفاء الأميركي الذي بات حتمياً من وجهة نظر الغالبية من مفكّري الاقتصاد العالمي، ومن وجهة نظر عشرات من مؤسسات البحث العلمي، ومن وجهة نظر رؤساء دول وقادة من كل أنحاء العالم، وبالتالي تتحول هذه الفضائح كلها غطاءً لما وصلت إليه الحالة الأميركية؟
لقد أسهبنا كما لاحظتم في طرح فرضيات فضائح القرن الجديد، وربما فضائح القرون كلها، والتي كشفت أن ثمة مجلس إدارة يتربّع على عرش هذه القذارات، وأن هذا المجلس يُدار بكل تأكيد من قوى عالمية مقتدرة، ومنظمة ومتنفذة ومتغلغلة في كل الاتجاهات والمستويات. لكن بعد كل هذا الإسهاب ما زال السرّ الأكبر غائباً.
كما هو ثابت فإن إبستين على علاقة لا تحتاج إلى إثبات بكل من المخابرات الأميركية والإسرائيلية، تعاوناً أو عضوية، وهو ما يعني بأن حالة من الابتزاز كانت هي الهدف، أو كانت في طريقها للتحول إلى هدف، وربما عدة أهداف دفعة واحدة.
إذا كان الأمر كذلك، والأرجح أنه كذلك فإنني أرى أن هذا الابتزاز هو فضيحة الفضائح إذ كيف وصلت اللوبيّات المؤيدة لإسرائيل إلى ابتزاز الدولة الحامية لدولة الاحتلال. وسنشهد على ما يبدو من ردود الأفعال في الشارع الأميركي ما لم يتم حسابه من قبل القائمين على هذه اللوبيات، والداعمين لكل ما تقوم به دولة الاحتلال، ليس في فلسطين، وإنما في الإقليم، وفي العالم كلّه، وسنتابع وسنتتبّع كلّ ذلك لاحقاً.
المصدر : وكالة سواجميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية
إقرأ المزيد